أبحاث
| |||
 25 يناير 2026 3:52 مدافوس: المشاط تستعرض تطور البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 25 يناير 2026 3:52 مدافوس: المشاط تستعرض تطور البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ 4 ساعاتدعم الاستثمار الصناعي يبحث عن آليات جديدة في ضل التحسن الجديد منذ 4 ساعاتدعم الاستثمار الصناعي يبحث عن آليات جديدة في ضل التحسن الجديد |
| |||
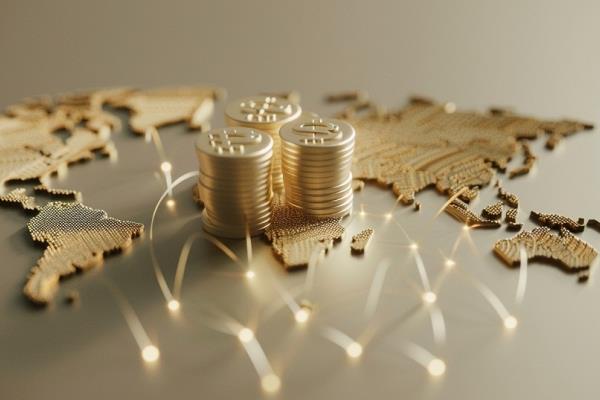
اعداد ـ فاطيمة طيبي
يشهد العالم في السنوات الأخيرة زلزالا اقتصاديا صامتا، يتمثل في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية على وقع التوترات الجيوسياسية، وتفاقم النزاعات التجارية بين القوى الكبرى، والتحولات العميقة في الممرات البحرية والبرية.
في قلب هذه العاصفة، تبرز المنطقة العربية، كلاعب محوري يسعى إلى الاستفادة من موقعه الجغرافي الفريد، وموارده الطبيعية، واستثماراته في البنية التحتية واللوجستيات، ليعيد التموضع في النظام التجاري الجديد الذي يتشكل أمام أعيننا.
في عالم يموج بالتحولات السياسية والاقتصادية، يطل الشرق الأوسط مجددا إلى واجهة المشهد العالمي، ليس فقط كمصدر للطاقة، بل كمركز محوري يعيد رسم خريطة التجارة العالمية. فعلى وقع النزاعات الجيوسياسية، والحروب التجارية بين القوى الكبرى، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، تقف المنطقة العربية أمام فرصة تاريخية للتحول من مجرد مورد وسوق، إلى لاعب استراتيجي في النظام التجاري العالمي الجديد.
هذه التحولات تناقشها، النسخة الثانية من منتدى هيلي الدولي، الإثنين 8 سبتمبر ، في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة واسعة من قادة سياسيين وخبراء اقتصاديين ورواد فكر وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم. ويبرز المحور الجيو اقتصادي، كأبرز محاور النقاش، حيث يستكشف المشاركون التغيرات الجوهرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل ما تفرضه التجزئة والحمائية من تحديات في ظل عصر العولمة، والفرص المتاحة أمام من يمتلكون القدرة على الابتكار والتموضع الاستراتيجي، بما يمكنهم من التعامل مع المشهد الاقتصادي المتطور.
بالعودة للخلف سنجد أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، هيمن نموذج التجارة الحرة المرتبط بمؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لكن العقد الأخير شهد تحديات غير مسبوقة لهذا النموذج، نتيجة صعود الحمائية والرسوم الجمركية، خصوصا بين الولايات المتحدة والصين.
حرب الرسوم الجمركية التي اندلعت عام 2018 بين واشنطن وبكين مثلت نقطة تحول حاسمة، إذ كسرت أوهام "العولمة بلا حدود"، وأعادت الاعتبار لفكرة "الأمن الاقتصادي" كعنصر أساسي في السياسات التجارية.
ومع تفاقم الصراع التكنولوجي والقيود على أشباه الموصلات وسلاسل التوريد، بدا واضحا أن التجارة العالمية لم تعد تدور فقط حول الكفاءة الاقتصادية، بل حول النفوذ الجيوسياسي أيضا. ففرض الرسوم الجمركية المتبادلة كشف هشاشة الترابط المفرط بين الاقتصادين الأكبر في العالم. ثم جاءت جائحة كوفيد-19 لتعري نقاط الضعف في سلاسل التوريد العالمية، حيث توقفت المصانع وأغلقت الحدود، فارتفعت أسعار السلع ونقصت المواد الأساسية. وأخيرا، زادت الحرب في أوكرانيا من اضطراب الأسواق، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء.
ـ التجارة العالمية مكبلة بقيود الواقع :
هذه العوامل مجتمعة أعادت إلى الواجهة سؤالا كبيرا: هل تظل التجارة العالمية رهينة لمبدأ الكفاءة الاقتصادية وحده، أم أن الأمن الاقتصادي والجيوسياسي بات المحدد الأهم؟ أحد المفاهيم الأكثر تداولا اليوم هو "فك الارتباط"، ويقصد به تقليص الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة والصين. هذا التوجه دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى البحث عن بدائل في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
دول مثل فيتنام والهند استفادت بالفعل من هذه التحولات، لكن المنطقة العربية تمتلك فرصة فريدة لطرح نفسها كممر بديل أو مكمل، نظرا لموقعها الاستراتيجي على طرق التجارة بين الشرق والغرب، وامتلاكها لموانئ متطورة مثل جبل علي في دبي، وميناء الدخيلة في مصر، وميناء الدقم في عمان.
ـ الممرات الاقتصادية:
إلى جانب إعادة توزيع سلاسل التوريد، يشهد العالم صعود "الممرات الاقتصادية" كأدوات استراتيجية لإعادة تشكيل حركة التجارة. ومن أبرزها: الممر الهندي - الشرق الأوسط - أوروبا (IMEC) الذي أعلن عنه في قمة مجموعة العشرين 2023، ويهدف لربط الهند بالخليج وأوروبا عبر شبكات لوجستية حديثة.
ثم تأتي مبادرة الحزام والطريق الصينية التي عززت النفوذ الصيني في موانئ وطرق بحرية برية تمتد من آسيا إلى أفريقيا والشرق الأوسط، ومن أهم الممرات أيضا، قناة السويس المصرية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية، ظلت لعقود شريانا رئيسيا للتجارة بين آسيا وأوروبا، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالمنافسة من طرق برية وبحرية جديدة. هذه الممرات ليست مجرد مشاريع بنية تحتية، بل أدوات لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والسياسي عالميا.
ـ فرصة نادرة :
المنطقة العربية تجد نفسها بين قوتين عملاقتين، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى. هذا الوضع يفرض على الدول العربية أن تلعب لعبة توازن دقيقة، بحيث تستفيد من الاستثمارات والتجارة مع الصين، دون أن تخسر القوى الغربية. هذا التوازن الدقيق يمنح العرب فرصة نادرة، الخليج مثلا أصبح أكبر مورد للنفط إلى الصين، وفي الوقت نفسه شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة الخضراء مع أوروبا وأمريكا.
ومصر تحاول أن تعزز دورها كبوابة لأفريقيا والشرق الأوسط عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصر، التي تتحكم في قناة السويس، تبني شراكات مع أوروبا وأمريكا، وفي الوقت نفسه تحتضن استثمارات صينية ضخمة في المنطقة الاقتصادية المحيطة بالقناة. هذا الوضع يمنح العرب أوراق قوة، لكنه يتطلب دبلوماسية حذرة لتجنب التحول إلى ساحة صراع بين القوى الكبرى.
ـ تجربة الإمارات والسعودية:
رغم الفرص، تواجه المنطقة العربية تحديات حقيقية في الاستفادة من هذه التحولات، في حين تمتلك الإمارات والسعودية موانئ ومطارات عالمية المستوى، تعاني دول أخرى من ضعف في شبكات النقل والخدمات اللوجستية، كما أن النزاعات في اليمن وليبيا والسودان، والتوترات في العراق ولبنان، كلها عوامل تهدد استقرار بيئة الاستثمار.
للتعامل مع هذا المشهد المعقد، بدأت العديد من الدول العربية في تبني استراتيجيات تكيفية، مثل تنويع الاقتصاد، فهناك رؤية السعودية 2030 والإمارات 2071 التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي متنوع يتجاوز النفط، علاوة على الاستثمار في الموانئ والمناطق الحرة، مثل توسعة ميناء جبل علي، ومشروع ميناء الدقم العماني، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واتجهت دول الخليج نحو إبرام اتفاقيات مع الهند والصين والاتحاد الأوروبي لتعزيز مكانتها كمركز تجاري، اضف لذلك الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وسلاسل التوريد الذكية لمواكبة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة.
ـ 3 سيناريوهات:
يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات مستقبلية محتملة لشكل التجارة العالمية ودور المنطقة العربية فيها،
ـ الأول، سيناريو الازدواجية، أي انقسام العالم إلى كتلتين الأولى أمريكية والثانية صينية)، وتضطر الدول العربية إلى المناورة بينهما لتحقيق أقصى استفادة.
ـ السيناريو الثاني التعددية، وهو صعود قوى إقليمية يؤدي إلى نظام تجاري متعدد الأقطاب، وهنا يمكن للعرب أن يلعبوا دور "الموازن" بين الشرق والغرب.
ـ السيناريو الثالث سيناريو الأزمات إذا استمرت النزاعات الجيوسياسية وتكررت الصدمات مثل جائحة كورونا أو حرب أوكرانيا، قد تتراجع التجارة العالمية ككل، مما يضغط على اقتصادات المنطقة.
التحولات الجارية تمنح العرب فرصة للتحول من مجرد مورد للمواد الخام أو سوق للمنتجات، إلى لاعب استراتيجي يحدد مسارات التجارة نفسها. مصر تسعى لتعزيز قناة السويس كممر عالمي لا غنى عنه، والسعودية تستثمر في مشروع "نيوم" الذي يضم موانئ ذكية، والإمارات تعزز دورها كمركز مالي ولوجستي عالمي.
إعادة هيكلة النظام التجاري العالمي ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل معركة على النفوذ والهيمنة، والشرق الأوسط والعالم العربي أمام فرصة تاريخية ليكون جزءا من الحل، وأن يركبوا موجة التحولات الجيو- اقتصادية ويعيدوا رسم دورهم التاريخي .
ـ بين أمريكا أولا و صنع في الصين .. التجارة العالمية تعيش لحظة الاحتضار :
كما اعتبر تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز" أن النظام التجاري العالمي الذي عرفه العالم لعقود يشهد انهيارا غير مسبوق. يحدث ذلك بالتحديد بسبب شلل منظمة التجارة العالمية وفقدانها القدرة على التفاوض أو الرقابة أو إنفاذ التزامات الأعضاء.
فالمبادئ الأساسية مثل "معاملة الدولة الأكثر تفضيلا"، التي تلزم الدول الأعضاء بمعاملة بعضهم على قدم المساواة باستثناء الاتفاقيات الحرة، تتآكل مع اتجاه واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بين 10% وأكثر من 50% على عشرات الدول، في ظل تبني الولايات المتحدة سياسة "أمريكا أولًا" والصين سياسة "الدورتين" و"صنع في الصين 2025" ـ وكلاهما يبتعد عن القواعد نحو منطق القوة .
وبحسب مايكل بي. جي. فرومان، وهو رئيس مجلس العلاقات الخارجية، والذي شغل سابقا منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة، كما عمل مبعوثا رئاسيا لقمم مجموعة العشرين ومجموعة الثماني خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، فإنه حتى لو بقيت أجزاء من النظام القديم، فإن الضرر وقع ولا يمكن محوه.
وكتب فرومان في تحليله أنه بينما يرحب البعض بنهاية مرحلة، فإن ما بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسياسة تجارية حمائية، قد يجر الاقتصاد العالمي إلى فوضى غير مسبوقة لاسيما مع حقيقة أن أكبر اقتصادين في العالم باتا يعملان خارج منظومة القواعد، ما سيدفع دولا أخرى لاتباع النهج نفسه، مؤديا إلى زيادة عدم اليقين وتباطؤ الإنتاجية وانخفاض النمو.
والمطلوب بناء شبكة جديدة من التحالفات الاقتصادية المرنة بين دول متقاربة الرؤى، لتكون بديلا عن النظام متعدد الأطراف الذي كان قائما. هذه الشبكة قد تضم تحالفات للتكامل التجاري، أو لتأمين سلاسل الإمداد، أو حتى لتقييد التجارة بدافع الأمن القومي، مع تداخل محتمل بين عضويات الدول. ورغم أن هذا النظام أقل كفاءة اقتصاديًا، فإنه قد يكون أكثر استدامة سياسيًا ويمنع الانزلاق نحو فوضى أحادية.
ـ تحدي الصين :
تكون النظام التجاري العالمي في ظل قيادة أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، مع إنشاء اتفاقية "الجات" وصولا إلى تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995 بعد جولة أوروجواي، التي وسعت نطاق القواعد وأطلقت آلية ملزمة لتسوية النزاعات.
وبعد الحرب الباردة، سعت واشنطن لضم دول مثل روسيا والصين للنظام، تعزيزا للاستقرار والانفتاح وحل النزاعات اقتصاديا.
وشكل صعود الصين أكبر اختبار للنظام. فانضمامها لمنظمة التجارة عام 2001 جاء وسط توقعات بانفتاح اقتصادي أكبر، لكن الإصلاح تباطأ تحت قيادة هو جينتاو وتراجع تحت شي جين بينغ.
القواعد المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ودعم الدولة والشركات المملوكة لها لم تصمد أمام حجم الصين الاقتصادي، الذي جعل فائضها الصناعي يقترب من تريليون دولار سنويا، وسط توقعات بأن تنتج 45% من الصناعة العالمية بحلول نهاية العقد.هذا الفائض، المدعوم بسياسات تفضيلية وحماية سوقية، قوض تكامل النظام، وتراجعت واشنطن خشية ترسيخ الامتيازات الصينية. ثم جاء ترامب ليطيح بما تبقى من التعددية التجارية، فيما لم تبذل إدارة بايدن جهدا لإصلاح المنظمة.
واليوم، توقفت أدوار المنظمة الأساسية: كمكان للتفاوض، اذ لم تحقق سوى اتفاقات محدودة مثل تيسير التجارة؛ وكجهة رقابية، لم تنجح في إلزام القوى الكبرى بالإفصاح عن سياساتها؛ وكآلية لتسوية النزاعات، تعطلت بسبب الخلافات حول جهاز الاستئناف، بعد أن منعت واشنطن إعادة أو تعيين أعضائه، ما شل النظام برمته.
ـ مكاسب وخسائر:
ورغم إخفاقاته، رفع النظام التجاري العالمي ما يصل إلى مليار شخص من الفقر، بحسب البنك الدولي، إذ تضاعف الناتج العالمي 3 مرات بين 1990 و2017، وتراجعت نسبة الفقر من 36% إلى 9% .
الاتفاقيات التجارية سهلت أيضا تصدير السلع والخدمات الأمريكية، وخفضت الحوافز لنقل الإنتاج إلى الخارج، ودعمت وظائف بأجور أعلى. وتشير تقديرات معهد بيترسون أشارت إلى أن الناتج المحلي الأميركي كان سيكون أقل من 2.6 تريليون دولار عام 2022 لولا مكاسب التجارة منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن الفوائد موزعة على نطاق واسع وغير ملموسة سياسيا، فيما الخسائر مركزة وتؤثر بشدة على مجتمعات صناعية محددة، كما حدث مع "صدمة الصين" بين 1999 و2011، حين تسببت الواردات الصينية في فقدان نحو مليوني وظيفة، نصفها في التصنيع. هذه الخسائر، رغم تواضعها نسبيا أمام حجم الاقتصاد الأمريكي، دمرت مدنا لم تتمكن من تعويض صناعاتها المفقودة .
ـ حروب الرسوم الجمركية :
استجابت واشنطن لثغرات النظام بشكل متقطع: فإدارة ترامب فرضت رسوما على الصين وحلفاء آخرين، بينما أبقت إدارة بايدن على الرسوم وأضافت قيودا على الصادرات والاستثمارات، خاصة في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية، دون إطار واضح يحد من تحولها إلى حمائية كاملة.
لكن بايدن تمسك مبدئيا بفكرة إصلاح المنظمة. أما ترامب فهو في ادارته الثانية يتبنى نهجا تفكيكيا، متحدثا عن "يوم التحرير" في أبريل 2025، وفرض رسوما تصل إلى 50% على عشرات الدول، ملوحا باستخدامها كسلاح في قضايا غير تجارية مثل الهجرة والأزمات الدولية.
هذه السياسات تهدد بزيادة تكلفة الواردات، ما يضعف تنافسية المنتجات الأمريكية، خاصة أن أكثر من نصف الواردات الأمريكية مواد وسيطة تدخل في الإنتاج. مثال ذلك رسوم ترامب في 2018 على الصلب (25%) والألومنيوم (10%)، التي خلقت ألف وظيفة في صناعة الصلب، لكنها أضرت بـ75 ألف وظيفة في صناعات أخرى تعتمد على هذه المواد، مع تراجع إنتاجية قطاع الصلب بنسبة 32% منذ 2017.
ـ عدوى عالمية :
في المقابل، فإن استخدام الولايات المتحدة مبررات "الأمن القومي" لتقييد التجارة شجع دولا أخرى على النهج نفسه. ففي 2024، شهدت منظمة التجارة 95 حالة تنظيمية جديدة تستند لمخاوف أمنية، شملت منتجات من الكاكاو إلى الأعلاف.
وهذا التصعيد، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي يخلقها، قد يكبح الاستثمار ويضغط على النمو وربما يطلق ركودا. النتيجة أن الاقتصاد الأمريكي يخوض تجربة غير مسبوقة، حيث التكاليف فورية وملموسة، بينما المكاسب المحتملة، إن وجدت، قد يستفيد منها عدد قليل وعلى مدى سنوات.
واختتم فرومان تحليله بالتأكيد على أنه لا عودة إلى نظام التجارة الذي عرفه العالم قبل عقدين. فالطريق أمام الاقتصاد العالمي قد يقوده إما إلى تفكك أكبر إذا تغلبت سياسات القوة، أو إلى نظام جديد من التحالفات المرنة التي تحافظ على قدر من القواعد المشتركة، وإن كان أقل شمولا وكفاءة. وفي الحالتين، سيكون النجاح مرهوناً بقدرة الدول على معالجة التحديات الداخلية وحماية مواطنيها من تقلبات الاقتصاد المعولم والتكنولوجيا المتسارعة .
| |||
 منذ 4 ساعاتدعم الاستثمار الصناعي يبحث عن آليات جديدة في ضل التحسن الجديد منذ 4 ساعاتدعم الاستثمار الصناعي يبحث عن آليات جديدة في ضل التحسن الجديد 25 يناير 2026 3:52 مدافوس: المشاط تستعرض تطور البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 25 يناير 2026 3:52 مدافوس: المشاط تستعرض تطور البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 21 يناير 2026 1:49 مأبرز الأحداث الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون في مصر خلال 2026 21 يناير 2026 1:49 مأبرز الأحداث الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون في مصر خلال 2026 18 يناير 2026 12:12 مأبوظبي: "القمة العالمية لطاقة المستقبل".. مؤتمرات تمهد طريق الكوكب لتعزيز الاستدامة 18 يناير 2026 12:12 مأبوظبي: "القمة العالمية لطاقة المستقبل".. مؤتمرات تمهد طريق الكوكب لتعزيز الاستدامة 14 يناير 2026 2:01 ممصر: توقيع اتفاقيتين مع "الاستثمار الأوروبي" و"التمويل الدولية" لضخ استثمارات بقيمة 137.5 مليون دولار 14 يناير 2026 2:01 ممصر: توقيع اتفاقيتين مع "الاستثمار الأوروبي" و"التمويل الدولية" لضخ استثمارات بقيمة 137.5 مليون دولار 13 يناير 2026 2:38 مقرارمهلة الصناعة تعيد تشغيل المشروعات المتعثرة وتدعم زيادة الإنتاج بالنصف الأول 2026 13 يناير 2026 2:38 مقرارمهلة الصناعة تعيد تشغيل المشروعات المتعثرة وتدعم زيادة الإنتاج بالنصف الأول 2026 12 يناير 2026 12:51 متعديلات قانون التجارة الصيني نقطة تحول للأسواق المصرية 12 يناير 2026 12:51 متعديلات قانون التجارة الصيني نقطة تحول للأسواق المصرية 6 يناير 2026 3:13 محصاد وزارة قطاع الأعمال 2025..126 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة بنمو 20% 6 يناير 2026 3:13 محصاد وزارة قطاع الأعمال 2025..126 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة بنمو 20% 5 يناير 2026 3:37 مماذا قدم الذكاء الاصطناعي للعالم في 2025؟ 5 يناير 2026 3:37 مماذا قدم الذكاء الاصطناعي للعالم في 2025؟ 4 يناير 2026 2:06 مأسواق المال في 2025.. الرابحون والخاسرون 4 يناير 2026 2:06 مأسواق المال في 2025.. الرابحون والخاسرون |









